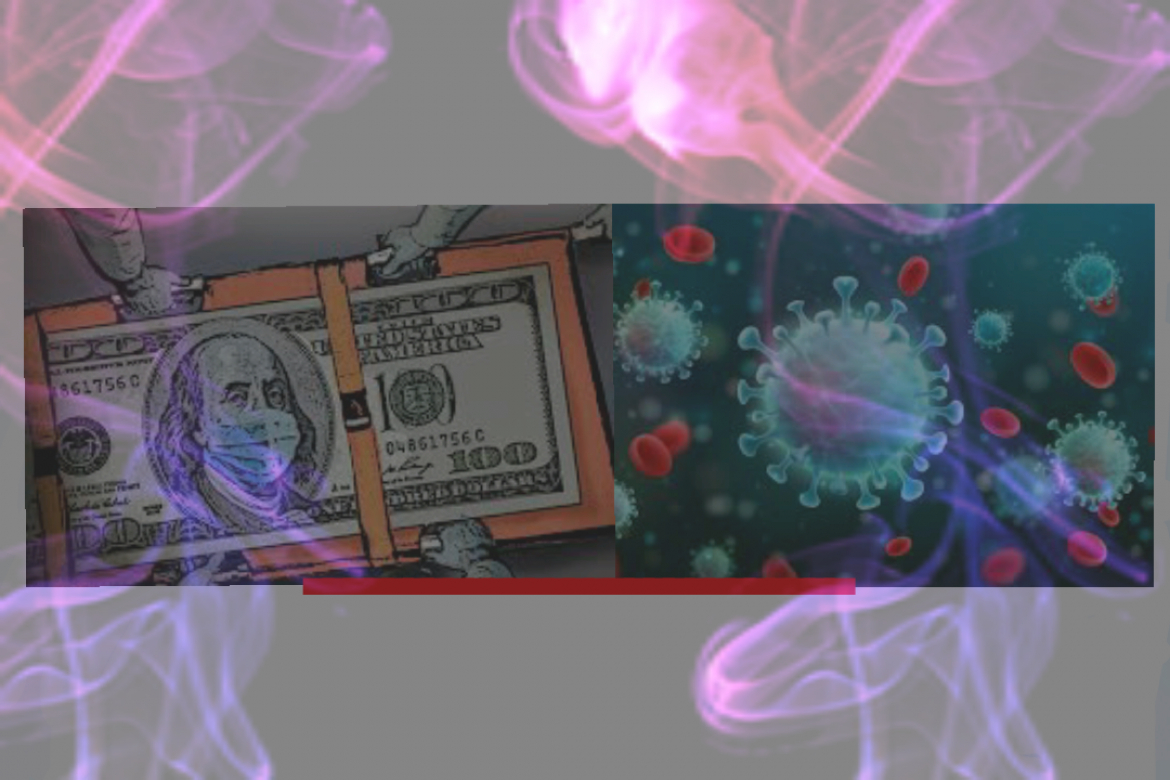ذاع صيتُ الصراع الطبقيّ منذ القرن التاسع عشر، لا سيما بعد أن صدر، البيان الشيوعي عام ١٨٤٨، حيث ركزّ وفق النظرية المادية التاريخية التي صاغها ماركس على الصراع بين من يملكون وسائل الإنتاج من جهة ومن يعملون ولا يملكون من جهة ثانية، واستطراداً بين الرأسماليين والعمّال، لكنّ التطور الاقتصادي في ما بعد ولا سيما في ظلّ النظام السائد اليوم، أدّى ويؤدّي إلى تحوّلات اجتماعية تُلحق أضراراً اقتصادية معيشيّة جسيمة، فلم يعُد التناقض الاقتصادي الاجتماعي المباشر يقتصر على ما بين الرأسماليين والعمال وحسب، بل شمل أيضاً الطبقات الاجتماعية المتوسّطة حتّى في الدول المتقدّمة وإن بدرجات متفاوتة، وشمل الشعوب في القارات التي توجّه إليها الرأسمال انطلاقاً من مراكزه الأوروبية الغربية والأميركية الشمالية. فنحن نشهد اليوم في أمريكا تفاوت طبقي واضح، فالشعب الأمريكي يؤمن أن الخمس الأغنى من الأمريكيين يملكون 59% من إجمالي الثروة، وأن الـ40% الأفقر يملكون 9%. لكن الحقيقة مختلفة بشكلٍ مدهش. حيث أن الـ20% الأغنى من إجمالي عائلات الولايات المتحدة يملكون أكثر من 84% من الثروة الأمريكية، أما الـ40% الأفقر فلا يملكون أكثر من 0.3%. تملك عائلة والتون، على سبيل المثال، ثروةً تزيد عن 42% من الأسر الأمريكية مجتمعةً. بالمناسبة، لطالما نظر الكثيرون إلى الولايات المتحدة على أنها "أرض الفرص" وتشبثوا بالحلم الأميركي الذي يحقق الرفاهية وإمكانية الارتقاء الاجتماعي لكل من يعمل بجد. لكن التباين "الشديد" في الدخل والثروة الذي تشهده البلاد منذ بضعة سنين أصبح يضع الحلم الأميركي أمام تحدٍ كبير. وفقاً لمكتب الاحصاء الاميركي، فإنّ عدد الفقراء في ال ٢٠١٩ بلغ ٣٤٠ مليون فقير. وضمن هذه الفئة، تعاني الكثير من العائلة العاملة من ذوي الدخل المحدود لتلبية حاجياتها الأساسية، وهو ما يعني أسرة من أصل ثلاث أسر أميركية. واتسعت الهوة بين الواحد في المئة من الأميركيين الأكثر ثراء وباقي الشعب لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ سنة 1928، استنادا إلى دراسة أعدها الخبير إيمانويل سايز من جامعة كاليفورنيا.
أمّا فيما خصّ الصحة النفسية، تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن حالات الانتحار تصل إلى ٨٠٠ ألف حالة سنوياً في العالم، أي بمعدل انتحار شخص واحد كلّ ٤٠ ثانية! بالإضافة إلى ذلك، فإنّ عدد الأميركيين مثلاً الذين ليس لديهم تأمين صحي يبلغ حوالي 30.4 مليون شخص عام 2018. في الحقيقة، غالباً ما يصاحب الحداثة الرأسمالية أيضًا شعور لا مفر منه بالفراغ العام والعزلة ونقص المعنى، الذي حاول العديد من الفلاسفة الوجوديين وعلماء الاجتماع مثل دوركهايم تفسير أسبابه. لا تسبب الرأسمالية الإجهاد والقلق فحسب، بل تجوف حياتنا عن طريق الإكراه على تكرار عمل غالبًا ما يكون له معنى ضئيل أو معدوم بالنسبة للأفراد، ولأن الدافع وراء الرأسمالية هو الربح وليس إشباع الحاجة البشرية. يتم صنع الأشياء فقط بقدر ما تحقق ربحًا، إذ تصنع الأشياء التي يمكن أن يشتريها الأثرياء بوفرة، مهما كانت تافهة، في حين يتم تجاهل توفير الأشياء اللازمة للأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع. هذا والجدير ذكره أنّ معدلات الفقر المدقع في العالم من المتوقع أن ترتفع خلال العام ٢٠٢٠، وذلك لأول مرّة منذ أكثر من ٢٠ عاماً.
في الخلاصة، وبناءً على ما تقدم، يبدو وكأنّ المجتمعات الرأسمالية وان بلغت مرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي والعمراني والتكنولوجي، الاّ أنّ الصحة النفسية لمواطني هذه المجتمعات ليست على ما يرام. يُستدلّ من ذلك جرّاء الاحاسيس المرتبطة بالخوف والقلق من الغد آلاتي، كما الشعور بالتعب والارهاق المزمن. انها دوّامة البحث عن معنى حياتك، فالمال ليس بالضرورة أن يصنع السعادة. عملت الرأسمالية على ربط المال بالسعادة من خلال تسويق مضخم لإعلانات وأفلام ومسلسلات ومنتجات ثقافية أخرى ربطت بين المفهومين بشكل وثيق. ترى هل كان العامل الذي أُستغل عندما عمل على فيلم من هذا النوع، هل كان سعيداً؟! أكاد أجزم الجواب: لا. اذاً، لا للرأسمالية!